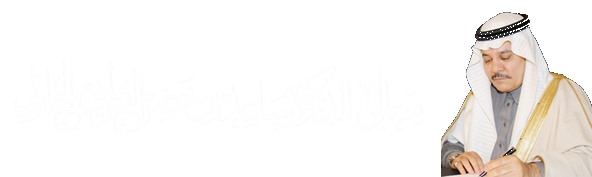الصحافة بين الخبر والدعاية
لعلكم تستغربون هذا العنوان، ربما لأنه أكاديمي بحت، وقد تقولون إن هذا الموضوع أولى به قاعات الدراسة في قسم الإعلام من قاعات المحاضرات العامة، وقد يهم طلاب الإعلام أكثر من ما يهم جمهور الرأي العام.
وربما لا يطول استغرابكم عندما تعلمون أن الأمر يتصل بالسياسة والفلسفة والأخلاق والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع، وله تأثيرات بالغة في العلاقات الدولية، سلباً وإيجاباً، وإن حاولنا الإحاطة بهذا الموضوع من كل جوانبه لما وسعته هذه المحاضرة، ولاحتاج إلى جلسات وجلسات قد تمتد طويلاً، وفي الحقيقة أن موضوع (الصحافة بين الخبر والدعاية) موضوع طالما شغل بال الدارسين والعاملين في مجال الإعلام.. ولن ندخل في التفاصيل الدقيقة ولن يتجاوز التناول هنا آراء ورؤى شخصية مع بعض الشواهد.. ولذلك فإنّ حديثي لكم سيكون مجرد خواطر لإنسان امتهن العمل الصحافي ودرس وبحث في النظريات والتطبيقات الأكاديمية المختلفة, وقبل أن نلج إلى صلب الموضوع سنحاول التعرف باختصار على ماهية كل مفردة من مفردات هذا العنوان.
وسنبدأ بكلمة “صحافة” لأنها أشمل، وفي كثير من الأحيان تستخدم الكلمة كناية عن الإعلام، فماذا تعني كلمة “صحافة”؟ يُعرِّف علماء الإعلام وأساتذته الصحافة بأنها: فن تسجيل الوقائع اليومية بمعرفة وانتظام وذوق سليم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه والاهتمام بالاتجاهات البشرية وتناقل أخبارها، ويقول آخرون: الصحافة مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآراؤها وأخطاؤها، وهي في رأي البعض- عملية تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة، والتعريف الشامل هو: أنها التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها دون أي تأثيرات خارجية ضاغطة كما في الدعاية، هذا من حيث المفهوم العلمي الصحيح للصحافــة، أما من حيث الممارسة فيبدو أن ليس هناك اتفاق بين الصحفيين على مفهوم موحد أو أساسي للصحافة، فهي عند بعضهم حرية التعبير، وعند آخرين التوجيه الاقتصادي أو الربح الذاتي، وعند فريق ثالث التوجيه السياسي، ويراها البعض في التغيير الاجتماعي، وفي دعم الأوضاع الاجتماعية والسياسية الراهنة وهكذا، وهناك مفاهيم أخرى كثيرة للصحافة تتعلق بالتوجيه والإرشاد والترفيه والتسلية علاوة على وظائفها الأساسية في تنوير الرأي العام وترقيته, ومهما يكن فإنّ الصحف تُعد من أقوى وسائل الإعلام، وأقدرها على تكوين الرأي العام وقيادته، ومن هنا تنبع أهميتها وخطورتها التي دفعت كل دول العالم تقريبا إلى احتوائها مباشرة أو عبر مؤسساتها الأخرى، ويقودنا هذا إلى الحديث عن حرية الصحافة، وموضوعيتها في تناول الأخبار والأحداث ومعالجتها.. فهل توجد صحافة حرة في عالمنا هذا؟
لن تكون الإجابة هنا مطلقة.. فالأمور نسبية والواقع الصحافي يختلف من مجتمع إلى آخر وفقا للنظام السياسي والحالة العامة للمجتمع، ولكن تشير بعــض الدراســات إلى أن العالــم اتجــــه بصفــة رئيسيــة إلى احتكار وسائـــل الإعــلام المطبوعـــة، وحتى في الديمقراطيات الحديثة- مثل الولايات المتحدة الأمريكية- نجد أن كثيرا من الصحف آلت ملكيتها بالشراء إلى المؤسسات الصحفية الكبرى، وعندما لا تكون الدولة هي المالك الوحيد لوسيلة الإعلام كما هو في بعض الدول النامية، أو ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي، فإنّ صحف القطاع الخاص التي تملكها شركات كبرى تحاول بشتى الوسائل التهام الصحف الصغيرة، ومن هنا ينشأ الاحتكار للمعلومة والرأي والتحكم في صناعة المواقف والاتجاهات، وهذا ملمح من ملامح تقييد الحرية في الصحافة، إذ إنّ المؤسسات الصحافية الكبرى كثيرا ما تغلب مصالح مالكي المؤسسة على المصلحة العامة.
ومع أنّ الصحافة في المجتمعات الغربية تقدم نفسها عادة كمدارس حرة، أو كيانات ذات صفة اعتبارية تعمل في مجتمعات مفتوحة خالية من الأسرار إلا أنّها غالبا ما تكون عرضة للمساءلة إذا تجاوزت حدود الصالح العام، أو استفزت المشاعـر الوطنية والمصالح القومية، وتكشف بعض الوقائع المعاصرة في عدد من الدول الديمقراطية أنّ بعض الصحفيين وصحفهم تعرضوا للمساءلة لأنهم تجرءوا على أسرار الدولة وعرضوا المصالح القوميـة لبلادهم للخطر، وحالتهم في هذه الحالة قد تصل إلى حد الخيانة العظمى، ولذلك فإنّ قلاع “المعلومات السرية” في دول الديمقراطيات الحديثة تختبئ في داخلها معلومات الفضاء والمعلومات العسكرية، والمعلومات السياسية المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومعلومات الثروات الطبيعية في باطن الأرض، والمعلومات الاقتصادية وتلك المتعلقة بنظم الاتصالات وحتى المعلومات الخاصة بالاختراعات في المجالات الصحية والطبية والصناعية وغيرها، بل إن أي معلومات عن ظاهرة الأطباق تعتبر من أسرار الدولة ولا يحق لأي صحفي الإطلاع عليها، وتقر الصحافة في تلك الدول مبدأ السرية هذه أو الحدود المقننة للحرية, وذلك تحت مظلة المسئولية الاجتماعية.. وهي النظرية الإعلامية التي أعقبت نظرية الحرية التي كانت أساس العمل الإعلامي في أوروبا قبل بداية الخمسينيات من هذا القرن.
أما في معظم دول العالم الثالث فــإنّ الصحف- مثلها مثل وسائــل الإعــلام الأخرى- إمّا مملوكة للدولة تماما، وتنحصر وظيفتها في دعم فلسفة النظام الحاكم وتثبيت دعائمه، وإمّا مؤسسات خاصة بإشراف الدولة ومتابعتها، ولذلك فإن الإعلام في هذه الدول يسير في اتجاه واحد، أي من أعلى إلى أدنى في أغلب الأوقات، والصحفيون موظفون أو شبه موظفين لدى الدولة وملتزمون بسياساتها وتوجهاتها ولا يجوز لهم تجاوز حدود وظائفهم المرسومة سلفا من قبل السلطة.
ونستطيع القول- ببساطة شديدة- إن جميع أنظمة الصحافة في العالم مرتبطة- كما يقول أساتذة الإعلام- بفلسفة الدولة ومجبرة على العمل من خلال ضوابط أيديولوجية واجتماعية معينة، وبالتالي فهي تعمل في ظل رقابة الدولة، ولكن لا بدَّ من الأخذ في الاعتبار الاختلافات في الأيديولوجية والتركيب السياسي والاجتماعي… فهذه الاختلافات هي أساس الفروق بين صحافة العالم… وهي التي على أساسها قسم الدكتور ولبورشرام صحافة العالم إلى صحافة تعمل في ظل نظرية السلطة المطلقة وأخرى تسير وفق نظرية الحرية’ وهي النظرية التي قلنا بأنها قد تلاشت منذ الخمسينيات، والنظرية الشيوعية, وقد شهدنا احتضارها ثم موتها منذ ما يقرب من سنتين، وأخيرا نظرية المسئولية الاجتماعية وهي النظرية السائدة في العالم الغربي وبدأت في العالم الشرقي مؤخرا، إذن يؤكد استقراء الواقع الإعلامي الدولي عدم وجود نظام صحفي أو إعلامي مطلق الحرية تحت أي مسمى كان، أو تحت أي مفهوم للحرية، فالقيود تفرض ولكن هذه القيود أكثر وضوحا في عالم النمو، فالصحف في معظم دول ما يسمى بالعالم الثالث لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تخرج عن إطار ما يسمى بنظرية السلطة، بل هي عاجزة تماما عن أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المعلومات الحقيقية والصادقة عن أي نشاط من النشاطات الإنسانية.
عفوا لهذا الاستطراد…
ولكن الحديث عن الخبر والدعاية في الصحافة لا بدّ أن تسبقه خلفية أو ملمح سريع عن حرية الصحافة، لأن الممارسة الصحفية في عصرنا الحالي تفتقر إلى عنصر الموضوعية، وبالتالي فإن المفهوم الأكاديمي للخبر تداخل مع مفهوم الدعاية، بل إن مفردات: إعلام دعاية، إعلان، أصبحت تتداخل مع بعضها بشكل كبير حتى أنه لم يُعد في الإمكان التفريق بين الإعلام والدعاية في كثير من الأحيان، ولعلّ هذا ما حدا ببعض أساتذة الاتصال ودارسيه إلى القول بأن الإعلام هو الدعاية في عصرنا الحالي، نعم.. لقد تراجع المدلول الأكاديمي للإعلام كثيرا، ولم يُعد الإعلام هو نقل الحقائق المجردة، بل هو نقل الحقائق المصبوغة برأي ووجهه نظر النظام السياسي أو بثقافة مالك الوسيلة وبتكوينه الفكري والسياسي والأيديولوجي، وبطموحاته وتطلعاته واستراتيجياته.
ونعود إلى أحد مفردات محاضرتنا هذه وهو الخبر، فما هو مدلول الخبر؟ وما هي وظيفته وأهدافه؟
عموما ليس هناك اتفاق عام بين علماء الإعلام حول ماهية الخبر وطبيعته.
الخبر- أكاديميا- هو: الراوية الأمينة الكاملة غير المنحازة للأحداث ذات الأهمية والنفع للجمهور:
– وصف موضوعي دقيق غير متحيز للحقائق المهمة حول واقعة جديدة تهم القراء.
– تقرير عن فكرةٍ أو حادثٍ أو صراعٍ صفته الحالية والجدة ويهم القراء.
– رواية حدث حالي يثير الاهتمام.
– هو عصب الصحافة الحديثة.
وعلى العموم هناك مئات التعريفات الخاصة بالخبر، وجميعها- أو جُلها- يشير إلى أهمية الموضوعية في الرواية الإخبارية باعتبار أن الخبر ليس ملكا للصحيفة ولا للرأي العام، وإنما هو فقط ملك للحقيقة، وعلى أساس أن الصحيفة التي تسعى إلى التأثير في الرأي العام عليها أن تتوخى الصدق الكامل في أخبارها، وإلا فإنّ تأثيرها في هذه الحالة سيكون ضعيفا إن لم يكن معدوما، والدقة في جمع ونقل وصياغة ونشر الأخبار هي أهم وظيفة للصحافة في عصرنا الحالي، والأخبار هي حجر الأساس في البناء الصحفي بل هي عصب الصحافة الحديثة ولولا الخبر لما عرفت المواد الصحفية الأخرى، وكلنا يعرف أن صحافة الرأي أفسحت المجال لصحافة الخبر، وأصبح دور الأخبار في صحافة اليوم يتركز في:
– تعريف الفرد بما يدور حوله من أنباء مؤثرة تتصل بأحوال مجتمعه وقضاياه والأنشطة المختلفة السائدة به.
– تعريف الفرد بقضايا الوطن الكبرى.
– تثقيف الفرد وتعريفه بوطنه ورموزه وثقافته وتاريخه وتراثه.
وإذا استطاعت الصحافة أن تحقق هذا الدور فإن تأثيرها على الرأي العام يكون أقوى وأعمق، وبالتالي تكون قد حققت وظيفتها الأساسية، يقول جيفرسون: الصحافة هي خير أداة لتنوير عقل الإنسان ولتقدمه ككائن عاقل وأخلاقي واجتماعي، وعموما فإنّ الصحافة وظيفة اجتماعية مهمتها توجيه الرأي العام، وتقاس حضارة أي أمة من الأمم بمدى تقدم صحافتها، وبمدى تأثيرها في الرأي العام، ويُعد الخبر هو أقوى الأساليب الصحفية تأثيرا في الرأي العام.
وقبل أن نتطرق إلى الموضوعيــة في الروايــات الإخباريـــة في الصحف المعاصرة ينبغي أن نتعرّف على ماهيــة الدعاية أولا، لأن الخبر الذي يفتقد الموضوعية، أو تدخل عليه عناصر التحوير والتبديل والتزييف يتحول إلى دعاية، ومن هنا تنشأ صعوبة التفريق بين الاثنين، إذ كيف يتمكــن القارئ العادي من تمييــز الخبر المغلف أو الملون بأساليب الدعايــة؟ إنه قــد لا يستطيع ذلك بالفعل.
ما هي الدعاية؟
هي: إحدى الوسائل القوية لكسب الناس إزاء فكرة معينة أو هدف معين.
وهي: كما يقول والترليبمان: محاولة التأثير على الجماهير والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكوك فيها، وذلك في مجتمع معين وزمان معين ولهدف معين.
وهي: فـن التأثيــر والممارســـة والسيطرة والإلحاح والتغييـــر والترغيـب أو الضمان لقبول وجهات النظر والآراء أو الأعمال أو السلوك أو كلاهما معا.
وهي: الاحتيال عن طريق الرموز.
وهي: ذلك النشاط أو الفن الذي يحمل الآخرين على سلوك معين ما كانوا يتخذونه لولا ذلك النشاط.
وقـد تنوعــت وتباينــت التعريفــات المختلفـة للدعاية ولكنها عموما تعني فن إقناع الآخرين بأن يسلكوا في حياتهم سلوكا معينا ما كانوا يسلكونه بدونه.
وعلى أية حــال فــإن الدعايــة تختلف باختلاف المشكلات والتركيبــة النفسيـة والاجتماعية والثقافية للشعوب، وهي تعتمد تماما – في محاولاتها للتأثير وأحداث السلوك المطلوب- على مخاطبة واستثارة العواطف مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ولكنها مع ذلك لا تُهمل العقل وإنما تحاول التأثير على سلوك الفرد بمخاطبة عقله.
وإذا كان هدف الدعايـة هو إقناع أكبر عدد من الناس في أقصر وقت ممكن فإن هذا يعني أن الدعاية والخبر ضدان، فبينما يتوخى الخبر الموضوعية تنحاز الدعاية إلى جانب التحوير والكذب والتلفيق، وهي بهذه الصفة تهدد “قدسية” الخبر أو موضوعيته، وهذا هو الواقع في عصرنا الحالي، ونستطيع أن نؤكد – وهذا رأينا بالطبع – أن الخبر الموضوعي الصادق والمجرد، أو المفهوم الشامل للخبر كما نعرفه اليوم سوف لن يكون له وجود مع نهايــة هذا القرن، وربما يكون هذا حادث الآن – خاصة في عالمنا الثالث – وذلك لأن هناك نظريات حديثة خاصة بالدعاية تقول: إننا لا نستطيع أن نجزم بشكل قاطع بالحياد المطلق للدعاية كدعاية، فرجل الدعاية حين يدعو إلى شيء ما عليه أن يستخدم أي أسلوب يراه مناسباً لتحقيق التأثير المطلوب على سلوك الفرد، وقد تكون هذه الأساليب في حد ذاتها فاسدة أو طيبة، وقد يكون الغرض منها شرا أو إصلاحا، وسواء كان هذا أو ذلك فإنه لا يمس جوهر الدعاية كدعاية.
نعود الآن لنتحدث عن الموضوعية في الصحافـة المعاصرة والموضوعية بالطبع صفة من صفات الخبر، ومناقضة تماما للدعاية، فإذا توصلنا إلى أن وجــود الموضوعية يكون نسبيا إنْ لم يكن معدوما في الصحافة فإن هذا يعني أن جميع صفحات الصحف – بما فيها صفحات الأخبار – ما هي إلا مواد دعائيـة، وبالتالي فإن العنصر الإعلامي للصحيفة بالمفهوم الأكاديمي- يصبح ضربا من الفكر “الطوباري”.
ويؤكد بعض أساتذة الإعلام أن موضوعية الصحافة شيء مستحيل في هذا العصر، فالصحفي ينبغي أن يكون حرا ليكون موضوعيا، وهذا لم يُعد ممكنا في واقع الممارسة الصحفية, والحرية هنا لا تعني فقط الحرية السياسية كما يتبادر للذهن في أول وهلة ولكنها تتعلق بأمور عديدة، – فالصحفي- محكوم في البداية بوظيفته، وبتبعيته لرؤسائه ولمالكي الصحيفة، كما أنه محكوم بأيديولوجيته وثقافته وخبراته، وبالظروف والبيئة والتعليم وبالعديد من العوامل الأخرى، وهو في النهاية خاضع للمشاعر الوطنية العامة، ولمصالح مجتمعه، وبالتالي لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يعزل نفسه عن هذه العوامل التي تتحكم فيه، ويتعيّن عليه في هذه الحالة أن يضيف مرئياته الخاصة عند كتابة تقاريره ورواياته الإخبارية ويبرز ما يتوافق مع ميوله واتجاهاته ومعتقداته، ويجب أن يحجب أو يحذف تماما كل المعلومات التي يرى أنها تتعارض سواء مع مصلحته الخاصة أو مصلحة صحيفته أو وطنه أو توجهاته المذهبية وغيرها، صحيح أن الصحفي يمكن أن يكون موضوعيا من منطلق قدرته على استحضار كل تفاصيل القضية وروايتها دون أن يعمل فيها أو يسقط منها شيئا، فهل يتجرد الصحفي بالفعل ويقدم المعلومات كما هي؟ إن هذه مسألة مستحيلة، وإدعاء زائف، تقول به بعض الصحف التي تلبس زى الموضوعية، فالمحرر- بطبيعته كإنسان- يجب أن يكون انتقائيا، وحتى إذا استبعدنا هذه فإن مساحة صحيفته تفرض عليه الانتقاء، ومن ثم فإنه يصبح تلقائيا في التفاصيل والمعلومات التي يختارها بطابع ذاتي، أو يبدأ في عمليات الصياغة وفي ذهنه اعتبارات أخرى كثيرة، وتزاد بعد ذلك فيشكّل ويحرّف ويشوّه ويغيّر ويبدّل، ويعتدي على حاجز الموضوعية التي يطالب بها ويدعيها لنفسه ولصحيفته.
وعلى أية حال فإن الموضوعية في الصحافة، لا تعدو أن تكون مجرد خرافة، ومصطلح الموضوعية نفسه أضحى من المصطلحات التي يصعب فهمها على الرغم من أن الصحفيين يعتبرون أن التقاريــــر الموضوعية هي التي تخلو من أي شكل من أشكال المحاباة أو الدعاية، بل لا يتورعون في كثير من الأوقات من الإعلان بأنهم منصفون، وأن صحفهم تنحاز إلى مفهوم الانحياز إلى جهة تحت مظلة “الموقف المنصف” وهذا يعتبر ظلما في حق الجهة الأخرى، ثم ما هي معايير الصواب والخطأ في فلسفة الصحافة؟ كيف تحدد صحيفة ما أن سياسة جهة بعينها صائبة وما عداها خاطئ؟ وأنى لها الحكم بخطل أفكار وأيديولوجيات معينة، وتعظيم نظم وفلسفات أخرى تعتقد في إنقاذها للإنسانية؟ من الذي يملك القدرة على الحكم على الأشياء؟
ونخلص من ذلك إلى أن الصحف إذا افتقــرت إلى عنصر الموضوعيــة فإن موادها- بما فيها الأخبار- تدخل في إطار الدعاية، وينزلق الخبر إلى مجرى الدعاية إذا تعرض لأي ضغط من جانب الصحفي وهذا ما يحدث دائما تحت مظلات وتبريرات كثيرة ذكرنا معظمها، والدعاية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحافة، وفي حالات كثيرة تصنع وتصمم بواسطتها، وأصبح من المستحيل أن يتم التفكير في أي عمــل صحفي دون أن توضـــع الدعايــة في الاعتبــار، فهي تستغل بذكاء في عصرنا الراهن كجزء من العملية الإعلامية الكاملة، وهــذا ما حدا بالكثير من الكتاب أن يقـــول إنّ وسائـــل الإعـــلام جميعها بما فيها الصحافـــة، هي في حقيقتها دعاية.
وبالرغم من أن الخبر أو القصة الإخبارية في الصحافة هي القالب الوحيد الذي يعارض – أكاديميا- مفهوم الدعاية، إلا أن دراسي الدعاية ومصّمميها ومنفذيها يعترفون بأن الأخبار الموضوعية المحايدة يمكن أن تُعد- إذا استغلت بذكاء- من أحسن وسائل الدعاية، لأن محرري الأخبار دائما في وضع يسمح لهم فعلا بإقحام الدعاية أكثر من كتاب الافتتاحيات أو الزوايا دون أن يشعر القارئ بذلك، لأنه لا يتوقع منهم أصلا إلا أبراز الحقائق المجردة، وخاصة إذا كان هذا المحرر ينتهج خطا سياسيا أو أيديولوجيا موافقا لما ينتهجه القارئ, ويمكننا أن نتبيّن ملامح الدعاية في الروايات الإخبارية بوضوح إذا ناقشنا المسألة أكاديميا.
فمن المعروف أكاديميا أن مقدمة الأخبار تعتمد على إبراز أهم المعلومات والحقائق التي بُني أو يُبنى عليها الحدث، وعلى الصحفي الموضوعي أن يبدأ- في هذه الحالة- بالإجابة على أهم الأسئلة الستة المعروفة التي تشكل عناصر الخبر، فهل تتبع الصحافة العالمية وصحافة العالم الثالث هذا المنهج الأكاديمي المجرد؟ إن أهمية المعلومة الإخبارية تختلف بالطبع من بلد إلى بلد، وتقترن الأهمية كما قلنا سلفا بفلسفة الدولة ونظامها السياسي، فإذا كان السؤال (ماذا؟) هو الأهم عند صياغة خبر حول واقعة تهم كل شعوب العالم، فإننا نجد صحف الديمقراطيات الحديثة مثلا تركز على إجابة السؤال (لماذا؟) وصحف ما كان يسمّى بالمعسكر الشرقي ربما تربط السؤال بالأيديولوجية الشيوعية، أما في صحف العالم الثالث فإننــا نلاحظ أن التركيز في جميع الأخبار- أو جُلها- تنحصر أهميتـه في تقديم إجابة السؤال (من؟) بصرف النظر عن مضمون الخبر وأهميته، وهذه هي فلسفة نظرية السلطة، وهذا التوجه أو هذه الفلسفة يدخل الروايات الإخبارية في صميم العمل الدعائي.
وعموما فإن التقديم والتأخير في الأخبار تحكمه فلسفة كل دولة على حدة، والإبراز والإهمال للمعلومات يدخل في هذا السياق.
ولعل أهم منفذ للدعاية في مجال الأخبار والروايــات الإخباريـة هو (العنوان)، ولذلك فإن مهمة (المانشيتات) والعناوين الرئيسية تترك للضالعين في هذا المجال، والذين يعرفون أهميــة العنوان في التأثير على القارئ سلبا وإيجابا، والعنوان من الفنون الدعائية التي ترتكز على الجذب أو الإبعاد وفقا لهدف المرسل… وليس هنا مجال التفصيل في هذا الموضوع.
كما أن التشويش بتقنية الدلّال والميكانيكي في الأخبار يُعد عملا دعائيا ذكيا عند محاولة التأثير بالسلب على القارئ، وذلك علاوة على استخدام الأساليب البلاغية الفضفاضة في الرواية الإخبارية.
ونحن نعلم أن دخول بعض العبارات أو الصفات أو الاقتباسات والاستشهاد على الأخبار يفقدها معناها المتجرد أو مدلولها الأكاديمي، ويدفعها دفعا في طريق الدعاية.
وملمــح آخر من ملامــح اقتحام الدعايــة لمجال الأخبار ويمكن في استخدام المحرر في صلب تقريره أو روايته الإخبارية لعبارات مثل (الجديــر بالذكر، تجــدر الإشــارة… الخ)، ليس هناك ما هو جديــر بالذكــر، وإذا كان موجودا بالفعل فأولى به صدر الخبر لأصله، والمسألة برمتها لا تخرج عن القالب الدعائي، نعرف جميعا أن مثل هذه العبارات تستخدم في صحافة العالم الثالث بحكم العادة ولكنها عادة خاطئة يجب التنبيه لها.
وعلى أية حال فإن هناك أساليب كثيرة جدا للدعاية المستخدمة في الصحافة خصوصا وفي وسائل الإعلام عموما، وأصبحت هذه الأساليب تطل على القارئ عبر جميع مواد الصحيفة. ولا يمكن للصحفي والمحرر أن يتفادى الأساليب الدعائية وأن أراد ذلك.
وتتخذ الدعايــة الصحفيــة مرتكزات عــدة لتحقيق أهدافها وغاياتها سواء كانت هذه الأهداف سياسيــة أو دينيـــة أو تجاريـــة أو اقتصادية، وتصبح قادرة على التأثير في الرأي العام بسهولة ومن هذه المرتكزات على سبيل المثال:
– دراسة نفسية الرأي العام ومحاولة التأثير عليه من خلال نتائجها.
– الخلق والتجديد في العمل الدعائي حتى لا يؤثر الروتين على الحملة الدعائية.
– استخدام الدعاية والنكتة، وأثبتت هذه الأساليب النجاح الكامل في ظل الأنظمة القمعية.
– التكرار غير الممل، والذي يتم بصورة منظمة ومدروسة.
– الاقتباسات والاستشهاد من أقوال العظماء والمفكرين.
– التحريف، ويعني استخدام المهارة في تحريف الأخبار وتلوينها.
والأساليب الدعائية التي تلون الأخبار الصحفية أو المواد الصحفية عموما كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها في هذه المحاضرة، ولقد استخدمت الدعاية وخاصة الدعاية السياسية في الحروب والأزمات الكبرى بذكاء شديد، واستخدمت فيها الأساليب العلمية المتقنة، حتى لم يُعد في إمكان القارئ- متعلما كان أو أميا- أن يميز الدعاية بسهولة في أي خبر أو رواية إخبارية مثبتة، وأحيانا يعجز الصحفي نفسه عن إدراك حجم الدعاية في الخبر الذي يلتقطه من أي وكالة أنباء عالمية، أو من أي إذاعة عالمية، فالإذاعات ووكالات الأنباء العالمية بدورها توظف أخبارها لخدمة مصالحها وأهدافها، وتلون الأخبار بلون الفلسفة والسياسات التي تتبعها، وترتبط هذه السياسات ارتباطا وثيقا بفلسفة ونظم الحكم التي تعمل فيها مثل هذه الوكالات والإذاعات، وربما تكون الدعاية أحيانا مفروضة بشكل مباشر على الصحيفة من قبل النظام السياسي.
وقد عرفنا أن ديمقراطيات الغرب، أو الأنظمــة الحاكمــة في الغرب بمعنى أصح لها مكاتـب متخصصة في دراسة عقليات الشعوب وتركيباتها النفسية والثقافية والفكرية، ويتم استقطاب أفضل وأكفأ العقول للعمل في هــذه المكاتب، وبناء على نتائج هذه الدراســات تخاطب الشعوب، ويتم التمهيــد وفق ذلك لتوصيل الرسالة المعينة إلى الجمهور المعين للوصول إلى مدى محدود أو معروف من التأثير.
وأهم القوالب الصحفية التي يتم تسخيرها في العمليات الدعائية هو قالب الخبر، لأن الخبر الآن هو عصب الصحافة الحديثة، وهو أقرب إلى الصدق والموضوعية، والناس تميل عادة إلى الروايات الصادقة والأمنية، ولذلك فإن الدعاية- وخاصة السياسية- تستغل هذا الميل استغلالا كبيرا.
وإذا أردنا أن نسوق مثالا على ذلك فيمكن أن نرجع إلى ما قاله الرئيس بوش أثناء حرب الخليج، فقد قال قبل الحرب: إن الخطة الإعلامية ستتجه في ثلاثة اتجاهات، أولها خاص بالشعب العراقي، وثانيها بالشعوب العربية، وثالثها بالرأي العام العربي، أي أن الخطط الإعلامية تعمم بحسب تكوينات الشعوب وبحسب الخطاب أو الرسالة المراد توصيلها إليها.
ومهما يكن فإن حرب الخليج من الأمثلة القريبة التي تُعد مجالا ثرا لأساتذة الإعلام ودارسيه، فأي منهم يملك القدرة على الفرز يستطيع أن يخرج بنتائج مذهلة عن قوة الدعاية وتأثيراتها في مجريات الأحداث، وسيكتشف أن الخبر المغلف بالدعاية الناعمة لعب دورا جوهريا في صياغة الرأي العام والتأثير عليه… لقد كانت حرب الخليج حربا إعلامية بالدرجة الأولى، وكانت الروايات الإخبارية هي محور الخطط الإعلامية.
هذه ملامح مختصرة عن الصحافة بين الخبر والدعاية… وهي كما استمعتم مفاهيم يقوم عليها المضمون الصحافي في الصحافة المعنية بصناعة الرسالة وخاصة في المجتمعات الأكثر تقدما والأكثر وعيا، ولكن لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّه ليس كل الصحف تضطلع بصناعة مضمونها.. فالصحافة الموجهة هي صحافة مرسلة أكثر منها صحافة رسالة… إذ يقتصر دورها على الإرسال بصرف النظر عن مهمتها التي تفرضها طبيعة الصحافة ومفاهيمها الصحيحة، وصحافة من هذا النوع تعتبر بالمقاييس العلمية وسيلة فقط بين المتلقي ومرسل يكون خارجا عن ذاتها, سواء كان ذلك المرسل من داخل المجتمع وهو ما يتمثل في السلطات الحاكمة والشركات المالكة أو من خارج المجتمع مثل وكالات الأنباء العالمية الكبرى.. وهي الوكالات التي أصبحت قادرة على جدولة الاهتمام أو ما يسمى بالمصطلح العلمي (Agenda Setting) في العالم النامي وفقا لأهداف واستراتيجيات مصممة سلفا، وقد اشتكى العالم النامي عبر منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية مثل اليونسكو وعبر المؤتمرات الإقليمية من سلطة وكالات الأنباء العالمية واحتكارها للأخبار وبالتالي السيطرة – إلى حد ما- على رأي واهتمام الشعوب.. وبكل أسف انتهت تلك الشكوى إلى لا شيء.. ليس فقط لآن وكالات الأنباء الكبرى رفضت الحد من حركتها تطوعا أو أن المنظمات العالمية رأت أن الحل يكمن في تقوية الذات ولكن لأن وسائل إعلام الدول النامية نفسها تعيش مفهوما مختلفا عن مثيله في دول المقدمة، فالمفهوم الإعلامي السائد في الإعلام النامي يقصر المهمة الإعلامية على الإرسال بصرف النظر عن صناعة المادة.. وسواء كان ذلك بسبب الضعف الذاتي للوسائل الإعلامية وهذا عامل ملحوظ- أو بحكم عدم القدرة على الحركة الصحيحة نتيجة الضغوط الخارجــة عن إرادة المؤسسات الإعلامية أو بكليهما فإن ما يمكن التأكيد عليه هو أن صحافة معظم دول ما يسمى بالعالم الثالث أو النامي تنأى بنفسها بعيدا عن المفاهيم العلمية الصحيحة للصحافة.. بل إن المشكلة أو القضية الغريبة أن هذه الصحافة تستثمر الاجتهاد الذاتي والمحاكاة غير الناضجة ودور المرسل دون الاعتراف بالأسس العلمية لمهمتها كمنطلق لعملها.. وكثيرا ما نسمع أن النظرية ليس لها علاقة بالممارسة وكأن المعاهد والجامعات والمؤلفات والأبحاث والدراسات التي تُعنى بالعلم الصحافي وجدت من أجل الترف فقط.. على أية حال قد نعذر هذه الصحافة لهذا المفهوم فيما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة نشأتها والظروف المختلفة التي تعيش فيها.
أرجو أن تكونوا قد وجدتم فيما قيل بعض الفائدة.
والسلام
د. ساعد العرابي الحارثي
1412هـ -1991م
النادي الأدبي الثقافي بجدة